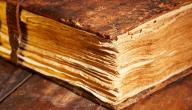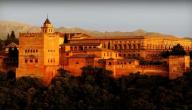محتويات
أنواع الوثائق التاريخية
تنقسم أنواع الوثائق التاريخية إلى: وثائق أرشيفية، ووثائق دبلوماتية، وتفصيلهم فيما يأتي.
الوثائق الأرشيفية
لماذا تختلف أنواع الوثائق الأرشيفية عبر التاريخ؟
هي الوثائق التي يتمّ الاستناد إليها من أجل معرفة التاريخ واستنباطه، وتختلف أنواع الوثائق الأرشيفية وذلك حسب المعلومات التي تحتويها والموضوع الخاص بها، ومن تلك الأنواع:[١]
الوثائق التاريخية "الأرشيف التاريخي"
وهو الذي يحوي في طيَّّاته كافة المعلومات السياسيَّة والاقتصاديَّة والعسكرية الخاصََّة بتاريخ قطرٍ ما، ولمَّا تمّ تفصيل العديد من أنواع الوثائق الأرشيفية في الآونة الأخيرة فإنَّه لم يعد للأرشيف التاريخي أهمية كبيرة.[١]
الوثائق القضائية
تحوي هذه الوثائق جميع ما يخصّ المحاكم والأماكن الحكوميَّة والهيئات التّشريعية وكذلك القضائية، وكلّ ما يخصّ الرجال القائمين على تلك الهيئات القانونية وما تتضمنه معلوماتهم الشخصيَّة.[١]
الوثائق الأدبية والفنية
إنَّ ثقافة أي بلد لا بدَّ أن تكون محفوظة في أرشيفات خاصة بتلك الوثائق، إذ تعدّ تلك الأرشيفات بمثابة حكاية عن ثقافة البلد المقصود، فتُحفظ الدواوين والأشعار والأمثال والحكم، والفنون الأخرى والنشاطات الفنية والتي تتمثل بالمسرح والشعر والنحت وغير ذلك الكثير.[١]
الوثائق السياسية
تحوي تلك الوثائق على أهم الأحداث السياسيَّة والتي جرت في بلدٍ ما، ومَن هي الشخصيات السياسية المؤثرة في تلك الفترة، وما هي الأمور والمجريات التي استطاعت تغييرها والعبث بها، ولا بدَّ أن يحوي ذلك النوع من الوثائق على مجموعة المعاهدات والاتفاقيَّات التي أقامتها تلك الدولة مع الدّول الأجنبية الأخرى.[١]
الوثائق الإدارية
إنَّ لفظة الإدارة تتصل اتصالًا خاصًّا بمسألة الاقتصاد، وهذا يعني أنَّه لا بدَّ للوثائق الإدارية أن تحوي في طيَّاتها مجموعة وثائق تلك الإدارات والمؤسسات التي كانت قائمة في الدَّولة، وما هي أهم الاتفاقيّات التي تمّ إبرامها مع الشركات الأخرى، وما هي الصادرات والواردات التي تستطيع الشركة تبادلها مع غيرها من المؤسسات والشركات.[١]
أشكال الوثائق الأرشيفية
هل اختلفت طريقة التوثيق ما بين عصر والآخر حسب رؤية التاريخ؟
إنَّ الوثائق الأرشيفيَّة لا تتخذ لنفسها شكلًا واحدًا؛ ويعود سبب ذلك إلى التطور الحتمي على وجه هذه الكرة الأرضية، فكلّما اختلف الزمان اختلفت طريقة التوثيق، وتفصيل ذلك:
أرشيف الوسائط التقليدية
لمَّا ظهر الإنسان الأوَّل فإنَّه كان بحاجة إلى التّدوين، فكان يُحاول أن يرسم مجموعة من الأشكال على الصخور ويحاول أن ينحتها لتعبر له عن الشكل الذي يُريد، أمَّا في بعد ولمَّا ظهرت الكتابة فإنَّ الإنسان استطاع أن يكتب ما يُريده ولكنَّه وقع في نفس المشكلة، فلا يوجد ما يُمكن الكتابة عليه، فاستعان الإنسان بالألواح الطّينية وكذلك أوراق البردي أو جلود الحيوانات حتّى يستطيع أن يدوّن ويوثّق ما يُريده من الأمور، وعلى تلك الأشياء تُطلق لفظة الوسائط التّقليديَّة.[٢]
الأرشيف الورقي
إنَّ الحياة منذ الأزل في تطوّر دائم، والإنسان رهين عصره يتطوّر حسبما تقضي الحياة بذلك، ولعلّ من أهم ما وقفت عليه البشرية في تلك الآونة هو ظهور الورق، والذي مكّن الإنسان من كتابة ما يُريد بأسهل الطرق وأبسطها، فكلّ ما دوّن على الورق من كتابات وسجلّات ومراسلات بين الملوك يُطلق عليه جميعه اسم الأرشيف الورقي، ولا يُمكن لأي إنسان أن يُنكر ما قدّمه ذلك النوع من الأرشيف من خدمات مكّنت البشرية الحالية من الاتّصال بتاريخها.[٢]
الأرشيف المصور
قضت الحياة دائمًا بالتطوّر، ففي لحظةٍ ما لم تعد الكتابة قادرة على تصوير الأمور على حقائقها، وربما اختفت كثير من الحقائق التي لا يُمكن أن تُسجّل إلا بالصوت والصورة، فلو تمَّ الحديث مثلًا عن جبال الهيمالا فإنَّ الشخص سيصنع من خياله صورة لتلك الجبال، ولكن لو تمّ تصوير تلك الجبال مثل الأفلام الوثائقية فإنَّه سينتهي دور الخيال لتظهر الحقيقة في أبهى تجلياتها، وهذا ما يُطلق عليه اسم الأرشيف المصوّر؛ أي: توثيق كل ما تقع عليه العين من الأمور الهامة بالصوت والصورة.[٣]
الأرشيف الإلكتروني
إنَّ كل ما تمّ الحديث عنه من أنواع الأراشيف السَّابقة يمكن لكل إنسانٍ من الاطلاع عليه دون أدنى صعوبة، ولكن مع تطور الوسائل التقنية وزيادة سريّة المعلومات كان لا بدَّ من إيجاد طريقة لحفظ المعلومات بحيث لا يتمكّن من الاطلاع عليها سوى الأشخاص ذوي الخبرة العالية، وذلك ما يُسمّى بالأرشيف الإلكتروني، والمقصود به هو السلسلة من المعلومات الأولية المُسجّلة على أوعية إلكترونية، وتعدّ تلك المعلومة الوحدة الأساسيَّة في عالم المعلومات الإلكتروني.[٤]
أغراض الوثائق الأرشيفية
ما السبب الذي يدعو إلى الاحتفاظ بالوثائق الأرشيفية؟
إنَّ الوثائق الأرشيفية تختلف عن بعضها؛ وذلك بسبب الأغراض التي أُنشئت لها تلك الوثائق أصلًا، فمثلًا هناك الوثائق التي كانت في التاريخ القديم والتي تخصّ الولاة والسلاطين وطريقة حكمهم وكيفية اعتلائهم على العرش، وما إلى ذلك من المعلومات التي ترتبط بتلك الفترة الزّمنية فقط، أمَّا بالنسبة للعصور الوسطى فإنّ غرض الوثائق يختلف فيها؛ إذ ستتعرض الوثيقة للحديث عن أرشيفات الملوك والإقطاعات وكذلك الأرشيف البابوي وما إلى ذلك من الأمور.[٥]
صلة الوثائق الأرشيفية بالتاريخ
هل يُمكن الاستفادة من الوثائق الأرشيفية في الوقت الراهن؟
تنقسم الوثائق الأرشيفية بالنسبة لصلتها في التاريخ إلى قسمين، وهما:
الوثائق الأرشيفية الجارية
وهي الوثائق التي ما زالت تستعمل حتَّى الآن وهي لازمة للحياة اليوميَّة العادية، وينطبق عليها تلك الأرشيفات التي تُستعمل بشكل يومي في الدّوائر الحكومية، وهي أرشيفات لازمة من أجل اتّخاذ القرار الصحيح في الوقت الحالي، والقدرة على التّخطيط بشكل واضح للمستقبل، ويكون هذا الأرشيف بالغ الأهمية وذلك بالنّسبة للحياة العمومية ولو فُقد فإنَّه سيُسبب كوارث مدنية عالية.[٦]
الوثائق الأرشيفية التاريخية
يُطلق على الأرشيف التَّاريخي اسم الأرشيف الميّت، ولكن من رؤية خبراء التَّاريخ فإنَّ هذا الاسم يبدو تعسفيًّا بعض الشيء، فالأرشيف التاريخي ليس ميتًا على الإطلاق ولكن هو فقد أهميته بالنسبة للحياة اليومية، أي لم يعد قادرًا على تقديم الفائدة في هذا العصر، ولكن لهذا الأرشيف أهمية عالية بالنسبة للأشخاص الدّارسين في هذا المجال، فغالبًا ما يُقدّم لهم معلومات مهمّة تُفيدهم في أبحاثهم وتمكّنهم من الوصول إلى أهدافهم من تلك البحوث، ويحظى هذا النّوع من الأرشيف بأهمية عالية قلّ نظيرها.[٦]
الوثائق الأرشيفية حسب ملكيتها
إلى مَن تعود ملكية وثائق الإنسان الخاصة به؟
تقسم الوثائق الأرشيفية حسب مملكيتها إلى قسمين، وهما:
الأرشيف العام
وهي الوثائق التي تمتلكها المؤسسات الحكومية أو هي التي تقوم بإصدارها، يعني أنَّ تلك الوثائق لا تتبع في ملكيَّتها لجهة خاصة أو معينة، مثل أوراق الحكم الخاصة بالدّولة والأوراق الخاصة بسيادة تلك الدولة، وجميع التقارير والمسودات عن الاجتماعات التي تتم، والاتفاقيَّات التي تقوم الدّولة بإبرامها مع الطرف الآخر، وتُحفظ هذه الوثائق بوساطة موظفيين عموميين يكون لهم الحقّ بحمايتها فقط وليس بامتلاكها.[٧]
الأرشيف الخاص
أمَّا الأرشيف الخاص فهو الذي تعود ملكيته إلى صاحبه حتّى ولو كانت تمتلكه جهة عمومية؛ إذ ليس لها الحقّ في تملكه أو التصرف فيه، ومن الأمثلة على ذلك الأوراق الجامعية التّابعة لشخص ما وتمتلكها إدارة الجامعة، هذا المثال على مستوى خاص، إذ يختلف هذا التعريف ما بين عصرٍ وآخر باختلاف المتغيرات التي حوله، ولهذا النوع من الأرشيف أهمية عالية جدًّا، ويعدّ مصدرًا تاريخيًا بالغ الأهمية.[٧]
الوثائق الدّبلوماتية
ما هو علم الديبلوماتيك؟
الوثائق الدّبلوماتية هي نفسها الوثائق التاريخية بمختلف أنواعها وأشكالها ومضامينها، ولكن شكك العلماء بصحّتها فليسوا متفقين معًا على أنَّ تلك الوثائق التَّاريخية هي صحيحة بشكل تام، وإلى هذا التشكيك يعود فضل ظهور علم الديبلوماتيك وهو العلم الذي يهتم اهتمامًا خاصًّا بخلو الوثيقة التاريخية من التدليس والكذب والنحل الذي قد يحل بها عبر العصور، ويُطلق المختصون على ذلك العلم اسم: "علم تحقيق الوثائق"، ويعتمد التحقيق في تلك الوثيقة على أمرين وهما:[٨]
الشكل
إنَّ الشكل هو أحد العوامل المهمة التي يمكّن المحقق في علم الوثائق من الوقوف على صحة الوثيقة أو بطلانها، فمثلًا يتم فحص الوعاء الخاص بتلك الوثيقة ومقارنته مع الزّمن التي تعود إليه تلك الوثيقة، فمثلًا من غير المنطقي أن تكون هناك وثيقة مكتوبة على الورق وهي تعود في أصلها إلى العصر الجاهلي على سبيل المثال، وكذلك يقف على فحص الأختام والتحية والتاريخ، وهل كان هناك مَن يتبادل التحايا في ذلك الوقت بنفس الطريقة، وما إلى ذلك من الأمور.[٨]
المضمون
وذلك عن طريق الوقوف على الكلام الموجود داخل تلك الوثيقة، مثلًا إن كانت مكتوبة بنوع معين من أنواع اللغة وهل قد درجت تلك اللغة في وقتها، وما هو الفحوى الخاص تلك المعاني وهل كان متداول ذلك في تلك الآونة، والمقابلة بين تلك الوثيقة وغيرها من الوثائق المُثبتة للنظر في المعاني والكلمات وما إلى ذلك من الأمور.[٨]
المراجع[+]
- ^ أ ب ت ث ج ح بودويرة الطاهر، تثمين رأس المال البشري، صفحة 47. بتصرّف.
- ^ أ ب عبد الرحيم الحسناوي، الوثيقة التاريخية إضاءةٌ إبستيمولوجية، صفحة 113. بتصرّف.
- ↑ عبد الرحيم الحسناوي، الوثيقة التاريخيّة إضاءة إبستيمولوجية، صفحة 113. بتصرّف.
- ↑ عبد الرحيم الحسناوي، الوثيقة التاريخية إضاءة إبستيمولوجية، صفحة 113. بتصرّف.
- ↑ بودويرة الطاهرة، دراسة ميدانية بمراكز الأرشيف، صفحة 56. بتصرّف.
- ^ أ ب محاضرات في قسم التاريخ، الوثائق ومكانتها في التاريخ الإنساني، صفحة 5. بتصرّف.
- ^ أ ب بودويرة الطاهر، تثمين رأس المال البشري، صفحة 60. بتصرّف.
- ^ أ ب ت أحمد المصري، مصادر دراسة الوثائق العربية الإسلامية، صفحة 24. بتصرّف.