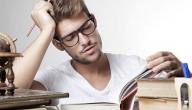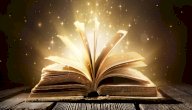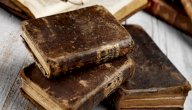محتويات
ما هي التوابع؟
تُعرف التوابع في اللغة العربية على أنها أسماء تتبع ما قبلها في العلامات الإعرابية؛ رفعًا، ونصبًا، وجرًا، ولذلك أُطلق عليها اسم التوابع، ويُطلق على ما يتبعها بالمتبوع، وتتضمن أربعة أنواع تُستخدم لتكميل متبوعها، أو إيضاحه أو تخصيصه.[١][٢]
ما أنواع التوابع؟
أقسام وأنواع التوابع أربعة، هم:
النعت
النعت أو الصفة من التوابع، ويأتي لبيان صفة الاسم الذي يتبعه في الإعراب، كأن نقول، (جاء الرجلُ الكريمُ)، فالكريم نعت دلّ على صفة في الرّجل، وهناك مجموعة من المعاني والأغراض التي يُفيدها النعت، كالتخصيص، والذم، والمدح، والترحم، والتوكيد، وللنعت نوعان، هما:[٣][٤]
- النّعت السّببيّ: هو الذي يدل على صفة في اسم له ارتباط بالمتبوع، أيّ له صلة بما قبله، ويتبع منعوته في أمرين اثنين فقط وهما الحركة الإعرابيّة، والتّعريف والتّنكير، ويأتي دائمًا مفردًا، كما أنه لا ينعت الاسم المسبوق على وجه الحقيقة، مثل، (جاء الرجلُ المهذبُ أخوه) فالمهذب نعت أرشدنا إلى صفة أخو الرجل، وليس الرجل نفسه، ولكن يمكن القول إنها صفة للرجل أيضًا بسبب رابط الأخوة التي بينهما، وإعرابها صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظّاهرة على آخرها.
- النّعت الحقيقيّ: هو ما يدل على صفة في نفس متبوعه، أيّ في اسم ما قبله، ويتبع منعوته في الإفراد والتّثنية، والجمع والتّذكير والتّأنيث، والتّعريف والتّنكير، ومثالًا عليه، (جاء الرجلُ المهذبُ)، المهذب هنا أتت صفة حقيقة في الرجل وإعرابها، صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها.
ومن الجدير بالعلم أن النعت الحقيقي قد يأتي بعدة صور، منها:[٥][٣]
- النّعت المفرد: وهو ما ليس جملة أو شبه جملة، ومثاله، قوله تعالى:" وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ"، وإعراب معلوم، صفة مرفوعة وعلامة رفعها تنوين الضّمّ الظّاهر على آخرها.
- النّعت الجملة: سواء أكانت الجملة فعليّة أم اسمية، ومثاله، قوله تعالى: "وَاتَّقُوا يَومًا تُرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ"، وإعراب جملة ترجعون، جملة فعليّة في محلّ نصب صفة ليومًا.
- النّعت شبه الجملة: أي الظّرف أو الجار والمجرور، ومثاله، (عصفورٌ في اليدِ)، وإعراب شبه الجملة في اليد، جار ومجرور في محل رفع نعت.
التوكيد
يُعرف التوكيد على أنه التابع الرافع احتمال إرادة غير الظاهر، وله رُكنان هما؛ المؤكِّد، والمؤكَّد، وقد يُسمّى توكيدًا أو تأكيدًا، ويأتي عادةً لتقوية متبوعه، وينقسم إلى نوعين، هما:[٦][٤]
- توكيد لفظيّ: يأتي لتكرار اللفظ الأول بعينه أو بمرادفه، سواء أكان اللفظ اسمًا، أو فعلًا، أو حرفًا ظاهرًا مثل، (الخيرُ الخيرُ قادمٌ)، فالخيرُُ هنا، توكيد لفظيّ مرفوع، وعلامة رفعه الضّمّة الظّاهرة على آخره، ، أو في جملة، مثل (حضرَ سعدٌ حضرَ سعدٌ)، فإعراب جملة حضرَ سعدُ، هنا جملة فعلية توكيد لفظيّ لا محلّ له من الإعراب، أو ضميرًا متّصلًًا مثل، (مررْتُ بكَ بكَ) فإعراب بك، هنا توكيد لفظيّ لا محلّ له من الإعراب، أما بالنسبة لمرادفه فيأتي على النحو التالي (فاز نجح الطلاب).
- توكيد معنويّ: يكون بألفاظ معيّنة تُذكر بعد الاسم لتوكيده، ويُشترط أن تُضاف إلى ضمير يعود على المؤكد ويطابقه في الجنس والعدد، من هذه الألفاظ: (ذات، نفس، عين، كلّ، جميع، عامّة، كلا، كلتا)، مثالًا عليها، (جاء الولدُ عينُهُ)، فإعراب عينُهُ، توكيد معنويّ مرفوع، وعلامة رفعه الضّمّة الظّاهرة على آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير متّصل مبنيّ على الضّمّ في محلّ جرّ بالإضافة.
وللتوكيد أدوات، منها ما يدخل على الأسماء والأفعال ومنها ما يدخل على الأسماء فقط، أو الأفعال فقط، وقد تأتي متصلة بالاسم والفعل، أو منفصلة عنه، ومن أهم أدوات التوكيد هذه: (إن، أن، لام الابتداء، نون التوكيد، لام القسم، قد).
العطف
يُعد العطف من أنواع التوابع التي تتبع ما قبلها بواسطة، أيّ يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف الآتية، والتي تُعرف بحروف العطف: (الواو، الفاء، ثم، أو، أم، لا، بل، لكن، حتى)، ومثالًا عليه، (نضج الخوخُ والعنبُ)، فالعنب هنا معطوفة على الخوخ والواسطة هي حرف العطف الواو.[٧][٤]
ومن الجدير بالبيان أن للعطف نوعان، هما:
- عطف النسق: هو النوع الذي يتوسط بين التابع ومتبوعه إحدى الحروف السابقة والتي يُفيد معظمها المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والإعراب، إلا ثلاثة منهم (بل، لا، لكن) حيث تُعطي فقط المعطوف حركة المعطوف عليه دون مشاركته في الحكم، وأطلق عليه النسق؛ لأنه ينسق الكلام بعضه على بعض، ومثالًا عليه (حضر زيدٌ ومحمدٌ)، فمحمد يُعرب هنا؛ اسم معطوف على زيد مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم الظاهر على آخره.[٨][٤]
- عطف البيان: يُعد عطف البيان من التوابع الجامدة التي تشبه الصفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة، أو تخصيصه إن كان نكرة، وهنا شابه التّوابع الأخرى بتبعيّة ما قبلها دون واسطة، ويُطابق متبوعه في الإعراب والتّثنية، والجمع، والتّذكير، والتّأنيث، والتّعريف، والتّنكير، ولكن يُشترط أن يكون تابعه أشد وضوحًا من المتبوع وإلا كان بدلًا، ومثال على ذلك قوله تعالى: "مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ"، وإعراب: زيتونةٍ هنا، عطف بيان على شجرة مجرورة وعلامة جرّها تنوين الكسر الظّاهر على آخرها.[٩][٤]
اقرأ أيضًا الفرق بين عطف البيان والبدل المطابق
البدل
هو التّابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه، ويُمهَّد له باسم يُذكر قبله، ويسمّى المُبدَل منه، ويتبعان بعضهما في الحركة الإعرابيّة رفعًا، ونصبًا، وجرًا، كأن نقول (واضعُ النّحوِ الإمامُ عليٌّ)، فعليّ بدل تابع للإمام في إعرابه، وهو المقصود في نسبة وضع علم النّحو إليه، والإمام هو المبدل منه، وجاء تمهيدًا له، فلو حذفنا كلمة الإمام لصحّ المعنى واستقام، وللبدل أنواع، هي:[٤]
- بدل كلّ من كلّ أو البدل المطابق: حيث يكون الاسم الثاني فيه نفس الاسم الأول، أو يمكن أن يحل محل المبدل منه، دون أن يتغير بالمعنى شيئًا، مثل (مررْتُ بأخيكَ زيدٍ)، فإعراب زيدٍ، بدل كلّ من كلّ من أخيك مجرور، وعلامة جرّه تنوين الكسر الظّاهر على آخره.
- بدل بعض من كلّ: البدل هنا يكون جزءًا حقيقيًا من المبدل منه أو بعضًا منه، كما يجب أن يتضمن ضمير يعود للمبدل منه ويطابقه، مثل (أكلْتُ الرّغيفَ كلَّهُ) فإعراب كلًّه، بدل بعض من كلّ من الرّغيف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظّاهرة على آخره.
- بدل الاشتمال: وهو الذي يكون فيه المبدل منه مشتملًا على البدل ومتضمنًا له، مثل (يُعجبُنِي زيدٌ خُلُقُه) فإعراب خلقُه، بدل اشتمال من زيد مرفوع وعلامة رفعه الضّمّة الظّاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متّصل مبنيّ على الضّمّ في محلّ جرّ بالإضافة.
- بدل المباين: وهو تابع لا يقع في فصيح الكلام؛ لأنّه قائم على خطأ أو وهم، أو نسيان، وقسّمه علماء اللّغة إلى:
- بدل الخطأ: وهو زلّة اللّسان، مثل (زارني زيدٌ عليٌّ).
- بدل النّسيان: وهو ذكر شيء ونسيان الأصل، مثل (أكلت التفاحةَ السمكةَ).
- بدل الإضراب: وهو ذكر أمر ثم الإعراض عنه، مثل (اقرأ نحوًا بلاغةً).
- بدل التفصيل: هو الذي يأتي تفصيلًا وتعدادًا لأجزاء المبدل منه، مثل (أحببت القادةَ عليًا وزيدًا وأسامةً وخالدًا)، فإعراب الأول بدلًا والبقية أسماء معطوفة.
أمثلة وتدريبات على التوابع
إليك في الآتي مجموعة تدريبات وأمثلة على التوابع:
- أكلتُ تفاحةً بل برتقالةً: اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره.
- قوله تعالى: "فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ": توكيد معنويّ مرفوع، وعلامة رفعه الضّمّة الظّاهرة على آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير متّصل مبنيّ على الضّمّ في محلّ جرّ بالإضافة، والميم للجماعة.
- الطلاب المهذبون يبتعدون عن المشاكل: نعت مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم.
- قوله تعالى: "كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا": توكيد لفظيّ منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره.
- قوله تعالى: "يَسْئلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ": بدل اشتمال من الشّهر مجرور، وعلامة جرّه تنوين الكسر الظّاهر على آخره.
المراجع[+]
- ↑ ابن عقيل، كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، صفحة 190. بتصرّف.
- ↑ الكتور محمد عبد اللطيف، التوابع في الجملة العربية، صفحة 5. بتصرّف.
- ^ أ ب علي الجارم، كتاب النحو الواضح في قواعد اللغة العربية، صفحة 377- 378. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث ج ح الدكتور عاطف فضل محمد، النحو الوظيفي، صفحة 325 -338. بتصرّف.
- ↑ علي الجارم، كتاب النحو الواضح في قواعد اللغة العربية، صفحة 380. بتصرّف.
- ↑ المتولي علي المتولي الأشرم، التوكيد في النحو العربي، صفحة 7. بتصرّف.
- ↑ علي الجارم، كتاب النحو الواضح في قواعد اللغة العربية، صفحة 397. بتصرّف.
- ↑ عبده الراجحي، كتاب التطبيق النحوي، صفحة 386. بتصرّف.
- ↑ ابن هشام النحوي، كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، صفحة 310. بتصرّف.
 ملخص المقال
ملخص المقال
التوابع في اللغة العربية هي أسماء تتبع ما قبلها في الإعراب، وتشمل أربعة أنواع: النعت، التوكيد، العطف، والبدل. النعت يوضح صفة الاسم، وله نوعان: حقيقي وسببي. التوكيد يقوي المعنى ويأتي لفظيًا أو معنويًا. العطف يتبع ما قبله بواسطة حروف العطف مثل الواو والفاء. البدل هو التابع المقصود بالحكم دون واسطة، وله أنواع مثل بدل كل من كل، بدل بعض من كل، وبدل الاشتمال.
 أسئلة شائعة
أسئلة شائعة
لا، لا يُعد من التوابع فالنعت يأخذ إعراب المنعوت، ولكن الحال دائمًا يأتي منصوبًا.
الفرق بينهما هو أن بدل الغلط يتعلق باللسان أم بدل النسيان فيتعلق بالجنان.