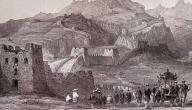محتويات
ما هي الوثيقة التاريخية؟
الوثيقة التَّاريخية هي ما يُشكّل الإرث الحضاري للإنسان، وهي مجموعة من الأوراق سواء كانت رسمية أم غير رسمية تم تجميعها عبر الزّمن، سواء كانت تلك الأوراق عامة أم خاصة مثل النشرات والدراسات والمخططات والخطابات وكذلك المذكرات، بالإضافة إلى مجموعة الأوامر والنّواهي والقرارات سواء كانت جمهورية أم ملكية، وزاريّة أم إداريّة، وتشمل الوثائق مجموعة الآثار والقطع الفنية التي تعود إلى حضارة معينة.[١]
أنواع الوثيقة التاريخية
ما هي أسس تقسيم الوثائق التاريخية؟
تُقسم الوثائق التّاريخية إلى قسمين اثنين، وهما:
الوثائق الأرشيفية
الوثائق الأرشيفية هي مجموعة الأوراق والوثائق التي تعود ملكيّتها إلى الدّولة فتكون رسمية، أو لجهات أخرى غير الدولة فتكون بذلك غير رسمية مثل: الجمعيات أو الهيئات التطوعية وما إلى ذلك، وتكون الوثائق الأرشيفية عبارة عن أوراق قد تكون مطبوعة أو غير مطبوعة، وقد تكون تلك الوثائق عبارة عن مجموعة من المراسيم أو القرارات التي تخصّ أفراد معينين أو لها قيمة اقتصادية أو ثقافية أو سياسيّة، وليس من الضروري أن تأخذ تلك الوثائق شكلًا واحدًا فمن الممكن أن تكون أوراقا كتب عليها، ومن الممكن كذلك أن تكون خريطة ما أو صورة فوتوغرافية أو تسجيل أو فيديو وما إلى ذلك حسب تطور العصور.[٢]
الوثائق الدبلوماتية
وهي الوثائق التي عادة ما يُثار جدلًا حول صحّتها، وإلى تلك الوثائق يعود فضل إنشاء علم الدبلوماتيك، وهو العلم الذي يُعنى بالتّأكد من صحة تلك الوثائق جميعها، ولا بدَّ من اتخاذ طريقتين للتأكد من الوثيقة كاملة، وذلك بدراسة الشكل والمضمون:[٢]
الشكل
تدرس الوثيقة التي تعود إلى حقبة تاريخية معينة عن طؤيق التركيزعلى الخصائص الشكلية أو المادية، مثل التدقيق في نوعية الحبر الخاصة بالوثيقة التي كُتب فيها، ويتم التدقيق كذلك على الأختام الموجودة على الورقة، وتفحص شكل الوثيقة من حيث شيوعها في تلك الفترة أم لا.[٢]
المحتوى
تعتمد دراسة وثيقة في عصر معين على مقارنتها بمحتوى وثائق أخرى تعود إلى ذلك العصر، فيُنظر إلى مدى تطابق الأحداث أو اختلافها، كما يتم النّظر في فحوى ذلك المحتوى واللغة التي كُتبت بها تلك الوثيقة.[٢]
لقراءة المزيد، انظر هنا: أنواع الوثائق التاريخية.
ما هو نظام الأرشفة الوطني؟
إنَّ الأرشيف الوطني هو المكان أو المؤسسة التي تحفظ بها الدّولة الأرشيف الخاص بها، وتختلف التّسميات تبعًا لكلّ دولة، ففي السودان ومصر يُطلق عليها اسم دار المحفوظات، ويُقال في إيطاليا الأرشيف المركزي، أمَّا في ألمانيا قيُقال عنه الأرشيف الفيدرالي؛ وذلك بسبب النظام الفيدرالي الذي تتتبعه تلك الدولة، وكذلك فإنّ كل الدول التي تتمتع بنظام فيدرالي يُطلق على أرشيفهم ذلك الاسم، وتختلف كذلك السلطة المشرفة على الأرشيف الوطني، فمن الدّول من تكون الأرشفة تابعة لرئاسة الجمهورية ومنهم مَن تكون تابعة للمكتبة الوطنية وغير ذلك.[٣]
الخطوات المنهجية لدراسة الوثيقة التاريخية
ما الخطوات التي تلزم الباحث للوقوف على أبعاد الوثيقة التاريخية؟
إنَّ لدراسة الوثيقة التاريخية مجموعة من الخطوات لا بدّ من اتّباعها، وهي:
الدراسة الظاهرية
تتمثل الدراسة الظاهرية للوثيقة التاريخية بمجموعة من الخطوات، وهي:[٤]
- تحديد الزمان والمكان الذي تعود إليه الوثيقة: لا بدَّ للمحلل من أن يكون محيطًا بالزمان الذي تعود إليه تلك الوثيقة ويعرف موقع تلك الوثيقة من الحلقات التاريخية المتسلسلة، ولا بدّ كذلك من معرفته الحيز الجغرافي الذي أنتجت فيه الوثيقة.
- معرفة الكاتب: لا بدّ من الإحاطة بالكاتب من كافة جهات حياته، كاتجاهه السياسي والفلسفي والديني، ومعرفة موقعه من المجتمع الذي كان يعيش فيه، هل هو مؤرخ هاوٍ أم هو مؤرخ بلاط، وما السبب الذي دفعه إلى الاهتمام بتلك الحادثة والكتابة عنها.
- شرح المفاهيم العامة: لا بدّ للمحلل من أن يبدأ بشرح الكلمات الصعبة التي يتمكّن من خلالها من تفكيك النص إلى أجزائه الصغرى والوقوف عليها.
- معرفة بُعد النص: إنَّ النص التاريخي يُوثق الأحداث التاريخية، لكن لا بدّ من معرفة البُعد الحقيقي لذلك النّص هل هو بُعد ثقافي أم اقتصادي أم سياسي أم غير ذلك؟
- ضبط عنوان النص: إنّ عنوان النص لا بدَّ أن يكون متوافقًا مع فحوى تلك الوثيقة بشكل تام.
- تقسيم النص: ويقصد بذلك تقسيمه إلى فقرات، ثم تحديد كل فقرة بناء على الفكرة التي تُناقشها، وبذلك تُستَخراج الأفكار الرئيسة للنص.
الدراسة الباطنية
إنَّ الدراسة الباطنية هي الدراسة الأعمق التي يُمكن من خلالها الوقوف على خبايا النص وفهمه فهمًا واضحًا حقيقيًا، ويتم ذلك من خلال ما يأتي:[٤]
- تحليل النص: يتم تحليل النص بالاعتماد على الخطوة الأخيرة من التحليل الظاهري، وذلك بالاستعانة بالأفكار الرئيسة التي حددها الباحث.
- إعطاء النص أبعاده الحقيقية: تتم هذه الخطوة بهدوء بالغ ورزانة عالية؛ إذ يتوقف عليها معرفة حقيقة هذا النص، ولا بدَّ من الابتعاد عن الأفكار الشخصية، وعدم شخصنة النص التاريخي بما يتناسب مع الأفكار والأهواء والمطامع الشخصية، وإلا سيتم تزييف التاريخ.
- التقيد بالنص نفسه: وذلك بألّا يعدّ الباحث هذا النص امتدادًا لغيره من النصوص، ممّا قد يؤدي إلى فقدان النص لقيمته التاريخية.
- نقد النص: إنَّ هذه الخطوة في تحليل النص تعدّ خطوة بالغة الأهمية، إذ يُعطي الباحث رأيه في النص ولكن لا بدَّ من أن يعتمد بذلك على النزاهة والخروج من التعصبات والبوتقة الشخصية، وعدّ مهمة النقد التمييز الحقيقي ما بين الحقّ والباطل.
- التقييم: من المهمات التي تترتب على الباحث بعد التحليل الظاهري والباطني تقييم الأحداث التاريخية التي مرّت بين يديه أثناء وقوفه على تلك الوثيقة، ويٌفضّل أن يكون ذلك على شكل تعداد بحيث يبث في روح الماضي التجديد، ويستطيع القارئ أن يستفيد من تلك الوثيقة في الحياة اليومية والعملية، وهذه من أهم الخطوات التي يتفاضل بها الباحث على غيره.[٤]
أهمية الوثيقة التاريخية
ما القيمة التي تحملها الوثيقة التاريخية للباحثين؟
إنَّ للوثيقة التاريخية أهمية كبيرة جدًّا تتلخص فيما يأتي:[٥]
- العودة إلى الوثائق باعتبارها المصدر الأوّل الحافظ للمعلومات، فهي يتمكن الشخص من الوقوف على كافة التفاصيل والوقائع وتاريخ وقوعها وأهم الأمور التي حدثت فيها وأهم المفاصل التاريخية في ذلك الحدث.
- الوثيقة التاريخية هي المادة التي يستمد منها الباحثون المادة العلمية وهي خام، فيستفيدون منها، وبذلك تُسهم بإثراء المكتبية التاريخية بشكل كبير جدًّا.
- الوقوف على الهوية الحقيقية لحضارة الشعوب الماضية والأمم القديمة، فكيف لنا أن نعرف للفراعنة مثلا لولا الوثائق التاريخية التي أعطت أدق التفاصيل عنهم، وكذلك الأمر بالنسبة للحضارات الكبرى لا سيما لاقديمة منها، مثلالحضارة البابلية، والكنعانية، وغير ذلك. وما زال العلماء حتى الآن يستفيدون من تلك الوثائق ويتدارسونها فيما بينهم.
- معرفة الجغرافيا القديمة للبلاد، فكيف يُمكن للقارئ أو الباحث الوقوف على الحيز الجغرافي القديم دون الوقوف على تلك الوثائق؟!
- مساعدة الباحث على التحقق من معلوماته، فهو يستطيع الوقوف على معلومات جديدة من خلال مقارنة الوثائق ببعضها.
- الوقوف على مجموعة التطورات التي جرت على طريق الكتابة، ومعرفة أهم الأدوات التي استُخدمت قديمًا في الكتابة وكيفية تطوّرها وصولًا العصر الحالي.
لقراءة المزيد، انظر هنا: تعريف الوثيقة التاريخية وأهميتها.
الفرق بين الوثيقة التاريخية والمخطوطة
كيف يُمكن التمييز بين الوثيقة التاريخية والمخطوطة؟
يكمن الفرق بين المخطوطة والوثيقة التاريخية في عدد من النقاط، وأهمها:[٦]
- المخطوطة يجب أن تكون بخط يد المؤلف نفسه أو بيد أحد قد أقره المؤلف على كتابة ما يُريده، أو تكون ربما نسخة أصلية منسوخة بخط اليد عن النسخة الأولى، لكن ليس شرطا أن تكون الوثيقة مكتوبة بخط اليد، إذ يوجد لها العديد من الأشكال.
- المخطوطة يجب أن تكون بين غلافين يربطها بداية ونهاية، أمَّا الوثيقة فليس من الضروري أن تكون مترابطة ببعضها.
- المخطوطة يجب أن تحاكي موضوعًا واحدًا من بدايتها وحتى نهايتها، أمَّا في الوثيقة فلا يجب ذلك، فقد تكون ورقة أو عدة أوراق مع بعضها وقد لا ترتبط الأولى مع الثانية بشيء.
كتب عن الوثائق التاريخية
ما أبرز الكتب التي تحدثت عن الوثائق التاريخية؟
لقد ألفت العديد من الكتب التي تتناول علم الوثائق التاريخية وأصوله وتاريخ تطوره، ومن أهم تلك الكتب:
- الوثائق التاريخية دراسة تحليلية: وقد كان هذا الكتاب من تأليف الأستاذين شوقي الجمل وعبد الله عبد الرزاق، وقد وقع الكتاب في 346 صفحة، تمَّت فيها مناقشة مسألة الوثائق التاريخية وتحليل كثير من تلك الوثائق.[٧]
- الوثائق التاريخية: محمد أحمد حسين، وقد وقع الكتاب في قرابة 146 صفحة، ناقش فيها مفهوم الوثائق التاريخية وأنواعها وكيف يتم تقسيم كل وثيقة بناء على محتواها وغير ذلك الكثير.[٨]
لقراءة المزيد، انظر هنا:أنواع المصادر التاريخية.
المراجع[+]
- ↑ محاضرات في قسم التاريخ، الوثيقة التاريخية مفاهيم ومصطلحات، صفحة 3. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث عبد الرحيم الحسناوي، الوثيقة التاريخية.. إضاءة إبستيمولوجية، صفحة 113 - 116. بتصرّف.
- ↑ حافظي زهير، الأنظمة الآلية ودورها في تلبة الخدمات الأرشيفية، صفحة 232. بتصرّف.
- ^ أ ب ت محاضرات في التاريخ، مدخل إلى النصوص التاريخية، صفحة 4. بتصرّف.
- ↑ محمود صهود، مفهوم الوثيقة التاريخية، صفحة 99. بتصرّف.
- ↑ مدخل إلى علم الوثائق التاريخية، الوثائق التاريخية، صفحة 4. بتصرّف.
- ↑ شوقي الجمل و عبد الله عبد الرزاق، الوثائق التاريخية دراسة تحليلية. شوقي الجمل و د. عبد الله عبد الرزاق، صفحة 5. بتصرّف.
- ↑ محمد أحمد حسين، الوثائق التاريخية محمد أحمد حسين، صفحة 5. بتصرّف.