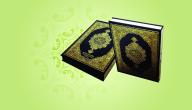محتويات
ربانية المصدر
إنّ معنى كون الشريعة الإسلامية ربّانيّة المصدر؛ أي أنّها من عند الله -تعالى- وحده، وهي الخصيصة الأولى من خصائص الشريعة الإسلامية؛ فالأحكام الإسلامية جميعها مستمدّة من كتاب الله -تعالى-، ومن سنّة نبيه التي أُوحى إليه بها.[١]
ومن القرآن الكريم والسنّة النبوية نتجت مصادر التشريع الأخرى كالإجماع والقياس والاستصحاب والاستحسان وغيرها، فهذه المصادر ليست معزولة عن مصادر التشريع الأصلية وإنّما تابعة لها وقائمة عليها، وإنّ الخروج عن مصادر التشريع إلى الأحكام الوضعية هو من قبيل التحاكم إلى الهوى.[١][٢]
العصمة عن الخطأ
أحكام الشرع الإسلامي مأخوذة من الوحي الإلهي، إمّا بطريق اللفظ وهو القرآن الكريم، أو بطريق المعنى وهي السنّة النبوية حيث إنّ ألفاظها من عند رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- ومعناها مُوحى إليه به من ربّه، ولذلك فهي معصومة من الخطأ، ومحفوظة من الزلل؛ لأنّها من عند الواحد الأحد، وهي مصونة من أن تُغيّر العقولُ والأهواء البشريّة شيئًا من أحكامها، مهما مضى من الأيّام والسنون.[٣]
ويوجد في كتاب الله وسنّة نبيّه أحكام موصوفة بالثبات وليست قابلة للتغيير والتبديل؛ وهذا فيما يخصّ العقائد والعبادات والأخلاق، وفيها أيضاً قواعد كليّة وقضايا عامّة يمكن استنباط أحكام جديدة منها؛ وهذا فيما يخصّ المعاملات، وبما يحفظ على الناس مصالحهم ويدفع عنهم المضرّة.[٣]
الثبات
إنّ الثبات في الشريعة الإسلامية مستمد على كونها شريعة حقّة، وما فيها من صدق غير قابل للتحريف، فقد ختم الله بها الشرائع السابقة وجعلها ناسخة لها جميعها، وقد تكفّل الله -تعالى- بحفظ كتابه العزيز وشريعته المعصومة، وهذا الثبات سيدوم إلى قيام الساعة، فالواجب يبقى واجباً، والحرام يبقى حراماً، وكذا سائر الأحكام الشرعية.[٤]
الشمول
إنّ الشمول خصيصة واضحة وجليّة من خصائص الشريعة الإسلامية، ومعناه أنّ هذه الشريعة ليست روحانيّة فقط، وإنما شاملة لكل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته، حيث نظّمت علاقة العبد بربّه ومعاملته لنفسه ومعاملته لغيره.[٥]
وما من قضيّة تستجدّ وتطرأ إلّا ولها حكم شرعي، إمّا منصوص عليه في كتاب الله أو السنّة النبوية، أو مُستنبط من القضايا الكليّة والعامة المقررة في دين الإسلام، فالاجتهاد والاستنباط والقياس والفتوى له أهله، والمطلوب من المسلم أن يسأل أهل العلم عندما يستجد في حياته شيءٌ ما ولا يدري ما حكمه، وسؤالهم هو استجابة لأمر الله -تعالى-.[٥]
الواقعية
تتسّم الشريعة الإسلامية بالواقعية فهي تتماشى مع الفطرة الإنسانية وتُلائم الطبيعة البشرية، مع تميّزها بالمثالية والسلامة من الخطأ وإمكانية التطبيق، ومن صور واقعيّتها ما يأتي:[٦]
- تقرير العقوبة والترغيب بالعفو والمسامحة.
- اجتثاث الأمراض الاجتماعية من جذرها بأنسب شكل وأكمل صورة، مثل التدرّج في تحريم الخمر.
- تشريع أحكام تضمن بقاء المجتمع بحالة طبيعية، فالزنا محرّم ولكنّ الزواج مُرغّب به وتسهيل أموره مُستحب في الإسلام، وإذا استحال استمرار هذا الزواج فباب الطلاق والفرقة مفتوح وفق أحكام خاصّة لا تجعل من هذا الأمر سهلاً يسيراً أو ممتنعاً مستحيلاً.
المرونة
إنّ الشريعة الإسلامية شريعة مرنة قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان، ومن مظاهر مرونتها ما يأتي:[٤]
- فتح باب الاجتهاد، والقياس وغيره من المصادر.
- احتواؤها على الكثير من القضايا عموما غير محدّدة التفاصيل كي يمكن تطبيقها في المسائل الطارئة والحوادث المتجدّدة، وهذا فيما يتعلّق بالسياسة الشرعية، ونظام القضاء والشورى وغير ذلك، مع مراعاة الظروف القاهرة والأعذار الطارئة.
- استناد الكثير من الأحكام إلى العُرف الذي تتغير الفتوى المبنيّة عليه بتغيّره.[٧]
التوسط
تتميّز الشريعة الإسلامية بالتوسّط، وهذا التوسّط شامل للعبادات والمعاملات، فهي وسطٌ بين الغلو والتهاون، وبين الإفراط والتفريط، فالصلاة خمس مرات في اليوم والليل يمكن للإنسان أن يحافظ عليها، ويلتزم بها بدون مشقّة زائدة.[٨]
والصوم شهر في السنة وكذا سائر العبادات، ومن القواعد الفقهية المقرّرة أنّ الضرورات تُبيح المحظورات والضرورة تُقدّر بقدرها، وغيرها كثير، وجميعها تدلّ على وسطية الإسلام واعتداله، وأنّه خاطب البشر وفقاً لاستطاعتهم ولم يُكلّفهم بالمستحيل.[٨]
ازدواجية الجزاء
تعني ازدواجية الجزاء في الشريعة الإسلامية أنّ الثواب والعقاب يشمل الدنيا والآخرة، وليست كالأحكام الوضعية التي يتوقّف فيها الجزاء على الدنيا، وهذا لا يجعل للجزاء هيبة في قلوب الناس؛ فمتى استطاعوا الهروب منه فسيزول عنهم ولن يُفكروا بالجزاء الأخروي.[٩]
وأمّا في دين الإسلام فالأمر مختلف فهيبة العقوبة والتذكر أنّ الله -تعالى- سُيحاسب الناس على ما قدموه من أعمال في الدنيا؛ له أثر كبير في الإقدام على فعل الخير، والإحجام عن الشر والظلم.[٩]
مخاطبة العقل والقلب معًا
إنّ الشريعة الإسلامية تُخاطب العقل، وتُبيّن له كثيراً من العلل والأسباب التي كانت وراء الأحكام الشرعية، وتدعوه للتأمل والتفكّر في الآيات الشرعية والكونية؛ حتّى ينقاد راغباً مُطيعاً، ويمتثل للأوامر وينتهي عن النواهي؛ لأنّ الفطرة الإنسانية تميل لفعل الأشياء طواعيةً واختياراً وليس إجباراً.[١٠]
وإنّ الأحكام الشرعية متلائمة مع هذه الفطرة وتُراعي دوافع الإنسان ورغباته ولا تكبت هذه الرغبات، وإنّما تضع لها أحكاماً مناسبة تضمن مصلحة الفرد وتحفظ المجتمع.[١١]
العالمية
إنّ عالمية الشريعة الإسلامية مُنبثقة عن عالمية الرسالة المحمّدية؛ حيث أرسل الله -تعالى- نبيّه لتبليغ الدعوة للناس كافّة من عرب وعجم وشرق وغرب، وعلى اختلاف مشاربهم وتنوّع عاداتهم وتقاليدهم، وإنّ شريعة الإسلام تصلح للتطبيق في كل أسرة وكل مجتمع وكل بلد؛ لأنّ مصدرها هو الإله الحقّ العليم بعباده والخبير بما يُصلح حالهم في الدنيا والآخرة.[١٢]
اليسر ورفع الحرج
اليُسر ورفع الحرج من السمات الظاهرة لشريعة الإسلامية، وهذه السمة هي نتيجة منطقيّة؛ لأنّها كاملة وربّانيّة، وقد بيّن الله -تعالى- في أكثر من موضع من كتابه العزيز أنّه يُريد اليُسر بعباده وليس العُسر، ومن صور هذا التيسير ما يأتي:[١٣]
- إباحة تناول المحرّمات عند الضرورة بقدر دفع الضرر فقط.
- إباحة التيّمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله.
- إباحة الإفطار في رمضان للمسافر والمريض.
المراجع[+]
- ^ أ ب منقذ السقار، تعرف على الإسلام، صفحة 39، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ منقذ الصقار، تعرف على الإسلام، صفحة 39 . بتصرّف.
- ^ أ ب جامعة المدينة العالمية، أصول الدعوة وطرقها، صفحة 103، جزء 1. بتصرّف.
- ^ أ ب محمد إبراهيم، فقه النوازل للأقليات المسلمة، صفحة 161- 164، جزء 1. بتصرّف.
- ^ أ ب محمد إبراهيم، فقه النوازل للأقليات المسلمة، صفحة 164، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ منقذ السقار، تعرف على الإسلام، صفحة 46- 47، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ محمد يسري إبراهيم، كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة، صفحة 161-163. بتصرّف.
- ^ أ ب عبد الرب نواب الدين، وسطية الإسلام ودعوته إلى الحوار، صفحة 15. بتصرّف.
- ^ أ ب جامعة المدينة العالمية، أصول الدعوة وطرقها، صفحة 104، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ التويجري، موسوعة فقه القلوب، صفحة 1473- 1474، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ جامعة المدينة العالمية، أصول الدعوة وطرقها، صفحة 103، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ عبد القادر عودة، الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه، صفحة 14. بتصرّف.
- ↑ سليمان الأشقر، نحو ثقافة إسلامية أصيلة، صفحة 181، جزء 1. بتصرّف.